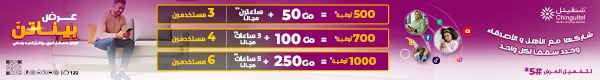مثّلت الثورة الصناعية التي ولدت انطلاقاً من بريطانيا، في منتصف القرن الثامن عشر، نقطة تحوّل كبرى في تاريخ البشرية. ومع تراكم المنجزات المادية والمعرفية والروحية التي بُنيت عليها، بات العالم، مع مطلع القرن الحادي والعشرين، ينقسم إلى جزئين: أحدهما متقدم (أي: متحضّر، استفاد من تلك المنجزات على صعيد المجتمع والدولة والفرد، وبات يتحكم بوجهة التاريخ) والآخر متأخر (أي: متخلّف حضارياً، كانت استفادته من تلك المنجزات محدودة، وغير شاملة، ومن موقع المتأثر لا المؤثر، فلم يعد يتحكم عملياً بمصيره ومستقبله، فضلاً عن مصير البشرية ومستقبلها)، والحال أن العالم العربي يُصنّف في الجزء الثاني، المتأخر.
كذلك، مثّلت العقود القليلة التالية للحرب العالمية الثانية ما يمكن اعتبارها "فرصة أخيرة" لتحقيق نجاحات حضارية ذات طابع مادي، يمكن أن تنعكس على صيغة نجاحات اجتماعية وسياسية، أي في المرحلة الأخيرة من التطور الصناعي الهائل، والذي أنتج لدى الدول المتقدمة، ضمن ما أنتج، تطوراً عسكرياً كبيراً، خصوصاً في جانب الأسلحة غير التقليدية، وفتح المجال، أخيراً، لتطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما زوّدها بإمكانات معرفية إضافية.
ثمة دول وأمم لحقت بتلك الفرصة الأخيرة، فأنجزت ما جعلها تظل داخل التاريخ، وقادرة على التأثير فيه، مثل معظم دول جنوب شرق آسيا. ومنها ما صار مؤهلاً للحاق بالدول ذات التأثير الكبير في العالم، واحتلال موقع يكافئ مواقعها.
ولكن، الأمم التي لم تلحق بتلك الفرصة، وظلت تعيش حياتها من موقع المستهلك والمنهوب والمتأثر، بفعل عدم صياغتها استراتيجية فاعلة للتقدم والتطوير، أو عدم تطبيقها الناجع من الاستراتيجيات دعا لها مفكروها، كما حال العرب، لأسباب سياسية على الأغلب: خارجية وداخلية، فإنها باتت بعيدة جداً، بالمعنى الحضاري، عن "الأمم المسيطرة"، ومن غير المعقول، موضوعياً، أن تنجح باللحاق بها، أو، على الأقل، أن تتمكن من التخلص من سيطرتها عليها، وتحكّمها في راهنها ومستقبلها، بالانطلاق من نقطة الصفر من جديد، وكأننا في أواخر القرن التاسع عشر، أو على الأكثر في منتصف القرن العشرين.
هكذا، تبدو الإمكانية المعقولة الوحيدة بالنسبة للأمم المتأخرة، للحاق بركب الحضارة، والدخول في مجال التأثير الإنساني، متمثلة في إقامة "تحالفات حضارية" مع الأمم التي تفوقها تحضّراً، لكي تستفيد مما لديها من منجزات، من موقع الشريك، لا من موقع المستهلك، فتتمكن من هضم تلك المنجزات ضمن مساعيها التحضّرية، على أن يكون لديها، في المقابل، ما تقدمه لحليفتها الناهضة، ما يفيد تلك الحليفة في ما هي عليه من تقدم، أو تستعمله في إدامة وتطوير تقدمها.
"لا يمكن إقامة المصاحبة بين أمّتين، مصالحهما الحضارية متنافرة"
حدث شيء من هذا، وإنْ بطريقة غير مباشرة، بين الصين ودول أوروبا الغربية المتقدمة، مثل ألمانيا وفرنسا، فقد استفادت الصين من التكنولوجيا التي تملكها تلك الدول، ابتداءً من تسعينيات القرن العشرين، بعد أن ضنّت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بها عليها، هذا في مقابل ما وفّرته الصين لاقتصاديات "حليفاتها" من فرص استثمارية هائلة. وقد كانت نتائج تلك "المصاحبة الحضارية" هائلة بالنسبة للنهضة التقنية في الصين، في تلك المرحلة.
ألا يمكن لنا، نحن العرب، أن نفكر بمصاحبة مماثلة، بدل أن نواصل العيش مستهلكين؟ للأمر شروطه على أي حال، فتلك "المصاحبة الحضارية" لا تقوم إلا على تحقيق مصالح مشتركة.
وهكذا، لا يمكن إقامة المصاحبة بين أمّتين، مصالحهما الحضارية متنافرة، كأن لا يكون من مصلحة الأمة المتحضرة أن تتقدم الأمة المتأخرة، أو أن لا يكون لدى الأمة المتأخرة ما هو نافع ومطلوب للأمة المتقدمة، أو أن يكون لديها ما هو مفيد، لكنها لا تستطيع أن تمنعه عن تلك المتحضرة التي تنهبها وتستغلها، وتسيطر على إرادتها.
وهذا يعني أن ثمة أهمية استثنائية للإرادة الوطنية، قبل التوصل إلى مصاحبة حضارية حقيقية، فليس معقولاً أن تصاحب أمة متحضرة أخرى متأخرة، لا إرادة لها، ومن ثم، لا برنامج عمل لديها.
كذلك، فإن تحويل تلك الإرادة إلى "خطة عمل" تنفّذها "أمة عاملة"، يحتاج قيادة واعية ومخلصة ومثابرة وبعيدة النظر، تعمل على حفز تنفيذ برنامج العمل النهضوي ومراقبته وتقييمه، فضلاً عن صياغته أو المشاركة بصياغته، وتجتهد في معالجة ما قد يظهر على حواف التطبيق من مشكلات وسلبيات. أليس ضرورياً أن نفكر بهذا كله، ولا نواصل العيش مستهلكين؟!