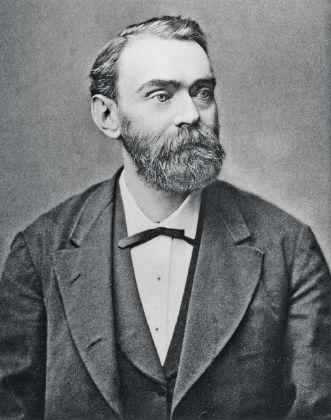
مع حلول تشرين الأول (أكتوبر) من كلّ عام، يعود الحديث عن جوائز «نوبل»، ولا سيّما جائزة الأدب منها. ولأنّها تكتسي أهميتَها وقيمتَها واعتبارَها وهيبتَها من عوامل عدة مثل قِدمها وعالميتها وارتباطها بجوائز أخرى في مجالات علمية معتبرة كالطبِّ والكيمياء والاقتصاد وغيرها، فإنّ أعضاء سكريتارية الجائزة يدركون حقيقةَ أنّ اختياراتهم تثير دائماً جدلاً لا ينتهي حول أحكامهم النهائية بإجازة هذا أو ذاك واستبعاد ذاك أو ذلك الآخر. لذا نراهم يحاولون استباق الجدل، خصوصاً الإنكاري منه، فيصحَبون قرارَهم دائماً بحكم نقدي قيمي تعليلي مُبرِّر للاختيار. ويحتفظون لأنفسهم وللأرشيف بتبريرات إبعادهم هذا الأديب أو ذاك، فتبقى حبيسة الأدراج خمسين سنة قبل إذاعتها والإفراج عنها كما يقرِّر قانون الجائزة، ومنه سيُعرف في يوم ما سبب عدم فوز أدونيس أو آسيا جبّار مثلاً، أو حتّى الأميركي فيليب روث وغيرُهم من المُرشَّحين الدائمين للجائزة، إن وصل إليهم الموتُ قبلها.
فرنسيون متوّجون
نستعرض هنا بعض الأحكام التي استندت إليها لجنة التحكيم في منح الجائزة، وسنقف أكثر مع أحكام تتويج الفرنسيين، باعتبار أنّ الفرنسيين كما هو معلوم هم الأكثر حصولاً عليها نسبة إلى غيرهم من أدباء الأمم والشعوب الأخرى، بدءاً بالشاعر سيلي بريدوم عام 1901 وانتهاءَ بباتريك موديانو في العام الحالي 2014. لنبدأ إذن من الحكم الأخير المُتعلِّق بباترك موديانو الفائز بجائزة هذه الدورة، فقد رأت اللجنة أنّه يستحقُّها لـ «فنيات التعامل مع الذاكرة، الفنيات التي استطاع بواسطتها تصوير مصائر إنسانية يصعبُ إدراكها، ولكشفه النِّقاب عن عالَم الاحتلال». والمقصود بالاحتلال هنا هو الاحتلال الألماني القصير جداً لمناطق في فرنسا إبان الحرب العالمية الثانية. ومع أنّ التبرير يبدو كأنّه انتصارُ لفنيات شكلية إجرائية، لا نجد أيّ إشارة إلى أيٍّ من هذه الفنيات، بل إنّ الجانب الأكثر بروزاً هو الجانب المضاميني - كما في معظم الأحكام الأخرى عبر تاريخ الجائزة - وطبيعة الموضوعات والعوالم المَرْوية في ذاتها. أمّا أليس مونرو المُتوَّجة عام 2013، المرأة/الكاتبة الكندية (الأنغلوفونية) الوحيدة الفائزة بالجائزة، فقد اعتُبرت «سيِدة فنّ القصة القصيرة المعاصرة»، إضافة إلى مواصفات أخرى تنصبُّ على المضمون أكثر من انصبابها على الشكل ضمّنتها الأكاديمية تعريفاً بالكاتبة. وهو حكم رأى فيه النقاد والملاحظون إعادة اعتبار من أكاديمية نوبل لفنّ القصيرة القصيرة المسكوت عنه دائماً في التقاليد السردية الحديثة لأنّه ليس في نظر الكثيرين سوى تابع للفنِّ الأساس: الرواية أو السرود الطويلة. ومثلها مثل موديانو الفائز بجوائز فرنسية عدة في مقدِّمتها «غونكور»، حصدت مونرو جوائز كثيرة في كندا، وقد كانا نَكِرتيْن - ككتّاب آخرين فائزين - بالنسبة إلى شرائح واسعة من القراء خارج فضاءيهما اللغويين.
أمّا عن الفرنسي الآخر ألبير كامو فقد رأت الأكاديمية أنّ مُبرِّر جدارته بالجائزة عام 1957 هو «مجموع أعماله التي تُلقي أضواء على المشاكل التي تنطرح أمام الوعي الإنساني». ورأى بعضهم تناقضاً بين بيان تبرير الجائزة والتصريح الذي ألقاه كامو في استوكهولم نفسها، أثناء محاضرة في جامعة أوبسالا، بحيث أثار (و مازال) موجة من الانتقادات والشجب، حين ردّ يومها على سؤال يتعلَّق بتطورات الثورة التحريرية الجزائرية: «بين العدالة وأمّي، أختار أمِّي»، وهو ما فُهم على أنّه انتصار للقمع الشديد والوحشية التي قابلت بها فرنسا الشعب الجزائري في مطالبته بالحرية، مع أنّ بعض الدارسين يرون بأن مقولة كامو قد حُرِّفتْ وأُخرجت من سياقها الذي عناه.
وكان داعي تتويج جان بول سارتر (الفرنسي أيضاً) عام 1964 هو «لآثاره (أعماله) التي مارست تأثيراً كبيراً على فترتنا هذه، ولروح الحرية والبحث عن الحقيقة». لكنّ رفضه الجائزة أحدث ضجّة إعلامية واسعة، وقد ردّ ذلك إلى أنّ الجائزة «تميل كثيراً إلى الغرب» (الغرب هنا بمفهومه الإيديولوجي الذي ساد بعد الحرْب العالمية الثانية، لا بمفهومه الحضاري المعروف لدينا).
وهو موقف إيديولوجي لا غبار عليه يمكن إدراجه بسهولة في سياق الحرب الباردة التي كانت في أوجها آنذاك. أمّا جان ماري غوستاف لوكليزيو، الفائز بدورة عام 2008، فعزت الأكاديمية اختياره إلى أنه «كاتب - ينطلق - من منطلقات جديدة. من المغامرة الفنية واللذّة الإحساسية (الشعورية)، مستكشفٌ إنسانيةً تقع في ما وراء الحضارة السّائدة ودونها».
مفاجآت نوبل
شكّل ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا وأحد القادة المشهورين أثناء الحرب العالمية الثانية وأحد أكبر المنتصرين فيها، مفاجأة دورة عام 1953 على أكثر من صعيد. فقد كان منتظَراً فوزُه في مجال السّلام وليس في مجال الأدب كما صرّح هو نفسُه بذلك، ما سبّب له خيبة أمل على نحو ما، خصوصاً أنّ كتاباته المتوّجة تنتمي إلى التاريخ وليس الأدب. وقد علّلت الأكاديمية فوزَه بـ «تحكُّمه (أو تمكُّنه) في الوصف التاريخي والسير - ذاتي، وكذا لخطاباته البارزة من أجل الدِّفاع عن القيم الإنسانية».
واستحقّ الكاتب الروسي بوريس ليونيدوفتش باسترناك الجائزة عام 1958 لـ «تجديداته الفنية (الشعرية) وكذلك لاندراجه ضمن التقاليد السردية الروسية». هنا أيضاً لا ذِكرَ لأيٍّ من هذه التجديدات. وقد وجد نفسه مضطراً لرفض الجائزة التي أثارت موجة استنكار وشجب في الاتحاد السوفياتي حينها واعتُبِر بسببها «عميلاً للغرب الرأسمالي ومناهضاً للشيوعية ومُعادياً للوطن». يتشابه ردُّ فعل السلطات السوفياتية هذا مع ما قامت به قبل تلك الحادثة بربع قرن، عام 1933، عندما جرّدت الروسي الآخر إيفان ألكسيفيتش بونين الفائز بجائزة من جنسيته. وبسبب الموقف نفسه، لم يتسلّم السوفياتي ألكسندر سولجنستين الجائزة التي نالها عام 1970 إلاّ بعد أربع سنوات، حين تمّ طرده من الاتحاد السوفياتي وسُحبت منه جنسيته.
أمّا الأميركي إرنست هيمنغواي فقد حكمت الأكاديمية بفوزه عام 1962 استناداً إلى «أسلوبه القوي والجديد الذي يتحكمُ به في فنّ السّرد الحديث، وهذا ما تؤكِّده رواية العجوز والبحر»، أسلوب حرّر به أقصر خطاب ألقاه فائزٌ في احتفالات تسليم الجائزة. نرى هنا التفاتاً إلى الشكل وفنيات السّرد على رغم أنّ كثيرين من النقاد يحبون هذا النصّ - على العكس من ذلك - لمضمونه القوي جداً في تصويره لمصارعة الإنسان للطبيعة وجهوده في مغالبتها تأميناً لوجوده وتمكيناً لسيطرته على غيره من مكونات العالَم الأخرى.
من الطبيعي أنّ المقاييس الأدبية والفنيةَ ليست هي الفيصل الوحيد في منح الجائزة لأديب أو منعها عن آخر، بل ثمة دائماً عوامل أخرى، لا سيما السياسية منها والديبلوماسية والجهوية والحضارية الثقافية، على رغم أنّ منطلقها الذي أوصى به مُنشِؤها هو: أن يكون الأثر المُجاز مُظهِراً أو مُبرِزاً قيمة مثالية قوية. لذا، يؤخذ على الجائزة الأشهر عالمياً تركيزها المُبالغ فيه على أوروبا في تحقيق فاضحٍ لمبدأ المركزية الأوروبية، من هنا تمّ منعها عن فيليب روث مثلاً الذي يُتكهَّنُ منذ فترة بتتويجه، أو حتّى الشاعر العربي السوري أدونيس أو الجزائرية الفرنكوفونية وعضوة الأكاديمية الفرنسية آسيا جبّار. وهي لم تُمنحْ، بناء على خلفيات سياسية، لأسماء بارزة مثل الفرنسي لويس - فرديناند سيلين صاحب رائعة «رحلة إلى آخر الليل»، التي يعتبرها كثير من الفرنسيين إضافة إلى «البحث عن الزمن الضّائع» لمارسيل بروست أحسن ما كتب في الأدب الفرنسي في القرن العشرين، أو عِزرا باوند مثلاً لكونهما مُتهمين بمواقف معادية للسامية وقريبة من الفاشية. علماً أنّ شائعات من هذا القبيل حامت حول غونتر غراس، الفائز بالجائزة عام 1999، والذي يُقال إنه انخرط في الجيش السياسي النازي في شبابه، وخورخي لويس بورخيس المتهم هو أيضاً بقربه من الأنظمة العسكرية الديكتاتورية السابقة في الأرجنتين والشيلي.
وفي المقابل، يعتبر بعضهم أنّ الجائزة مُنحت للأديب المصري نجيب محفوظ عام 1989 بسبب انخراطه في عملية السّلام والتّطبيع بين العرب واليهود ومساندته جهود الرئيس المصري الأسبق أنور السّادات في هذا المجال، عِلماً أنّ القيمة الأدبية الفنية لنجيب محفوظ لا غبار عليها ولا يختلف فيها اثنان. وقد تكون الرغبة في إحداث توازن جهوي وراء منحها عام 1968 للياباني ياسوناري كواباتا بتوصية من مُختصِّين في الأدب الياباني وللنيجيري الأنغلوفوني سوينكا عام 1986، وغيرهما. وممّا تجدر الإشارةُ إليه أن كُتّاباً كباراً انتقلوا إلى العالم الآخر في سنِّ الشباب، دون بلوغهم الخمسين، ما يعني ضِمنياً أنّ الكهولة - وحتى الشيخوخة - تعتبر معياراً لدى الأكاديمية في تسميتها الفائزين.
* اكاديمي جزائري






.jpg)





